الترجمة والتعريب
كثيراً ما يسهم اليوم المترجم العربي في الاضمحلال الثقافي العربي، إذ ينتهي عندما يسمى بالترجمة الوسيطة، وأقصى ما يصل إليه أحياناً، ولربما في الغالب الأعم، هو أن تكون ترجمته وظيفية تؤدي الفرض وهي غير مكتملة ثقافياً، فلا يرقى بها إلى المستوى البياني من التراث والمبني عليه، ومن أسباب ذلك عدم التركيز على المراجعة كأداة لضبط النوعية مثلما فعل الأوائل. وبذلك يتنزل، أو يكاد، إلى حضيض الترجمة الحاسوبية التي تقويها النزعة العولمية والتي تفتقر إلى العنصر الثقافي وتعوزها القدرة على الإعراب، بينا من المفروض فيه أن يدقق ويبين ويفصح، على عكس الحاسوب. ولا شك أن الحاسوب يمكن أن يقوم بدور كبير، وهو يفعل ذلك بالتدريج، نظراً لما يتيحه بالفعل من تدوين وإحصاء وتراكم معرفي وتصنيف تراثي، اختصاراً للوقت والمجهود، خاصة باستغلال الإمكانات التي يوفرها، ومنها الذاكرة الحاسوبية الترجمية، إذ يستحضر القوالب والتعابير والمنمطات لتوحيد الاستعمال، كما أنه أصبح يزخر بمعلومات تراثية قيمة، إذ يحتوي على كنز مكنون من روائع التراث العربي وغيرها.
لكن الخطر كل الخطر أن تثني الثقافة الحاسوبية، إن لم تسخّر وتستغل خير استغلال، عن التعلم والتثقف، فتضعف الملكة، وهما قوامها، وتصبح الترجمة حاسوبية ممسوخة ومنسلخة عن التعددية والخصومية الثقافية، مما يستلزم المواظبة على المطالعة وتقييد التعابير في فكرة كي ترسخ في الذهن، عن هموم وقضايا الترجمة والتعريب بين اللغة البيانية واللغة الحاسوبية وضمن هذا الإطار يأتي البحث في هذا الكتاب وهو بحث عملي الوجهة، مع بعض التنظير المرتبط بالتطبيق، للولوج إلى صلب المسألة بكل أبعادها الممكنة. وينقسم إلى أربعة فصول رئيسية هي: الفصل الأول: عنوانه من وحي التراث، ويرمي إلى تحديد المسائل اللغوية التي تهم المترجم، من لغة ونص وبيان وبلاغة وفصاحة... الفصل الثاني يتعلق بمقتضيات الترجمة. ويتناول هذا الفصل بالتفصيل علاوة على العودة إلى تعريف الترجمة، طرائق الترجمة،ووحدات الترجمة كما أن فيه أمثلة تتجسد فيها تلك الطرائف والوحدات. الفصل الثالث: يحتوي على ثمانية نصوص، ومعها شروح وتعليقات عليها وترجمات مقترحة لها ومع إيراد حلول بديلة، لكي يتبيّن القارئ منها دقائق العملية الترجمية وكيف يستعصي على الحاسوب أن يتصرف في الجمل من دون الإنسان. الفصل الرابع: له صلة بموضوع الترجمة والعولمة، ولا سيما الحَوْسَبة التي تعتبر من أهم روافدها. وفيه مقارنة بين النظرية التراثية للغة والترجمة والبعد البياني لها، خاصة عند أبي عثمان الجاحظ رائد البيان العربي وأول منظر عربي للترجمة وإن لم يكن مترجماً.






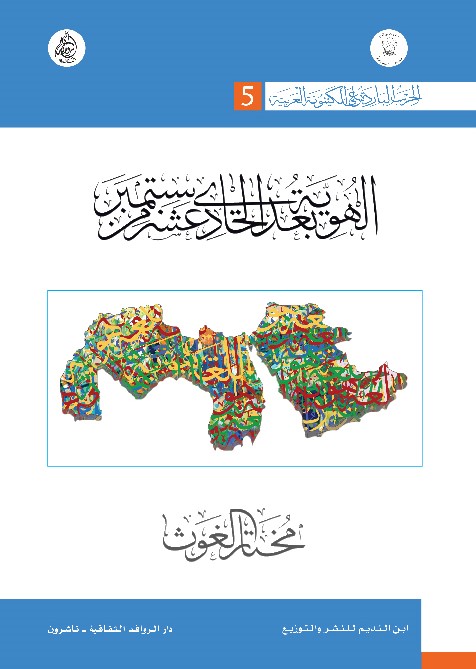
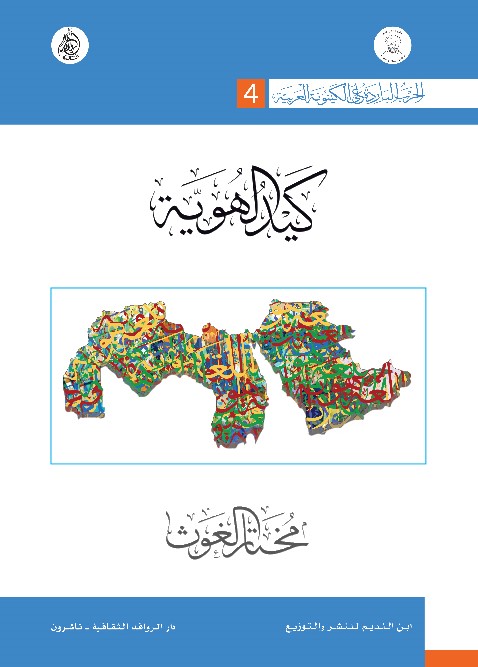
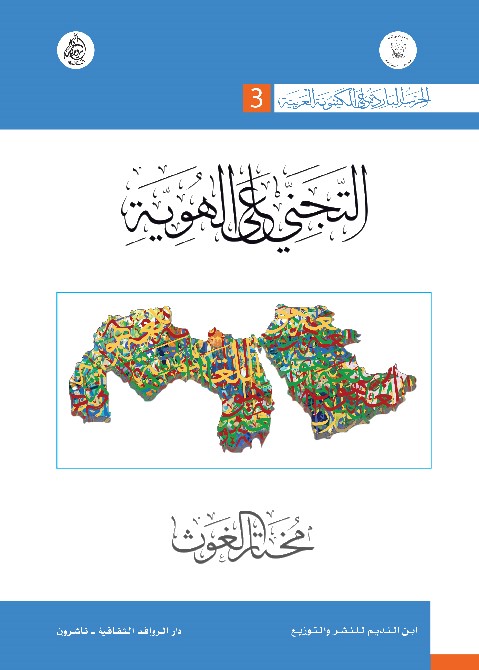

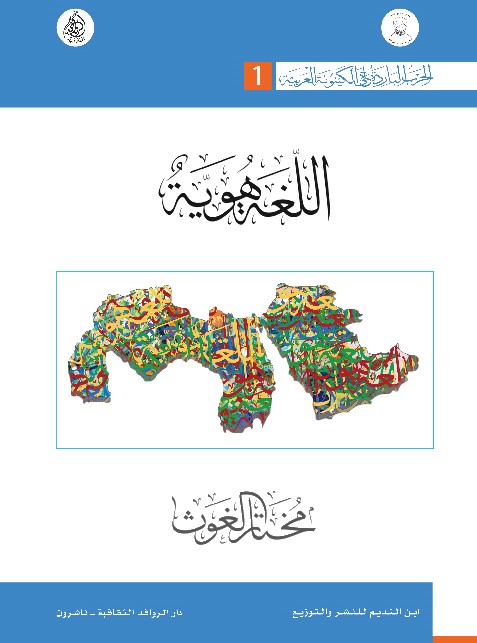
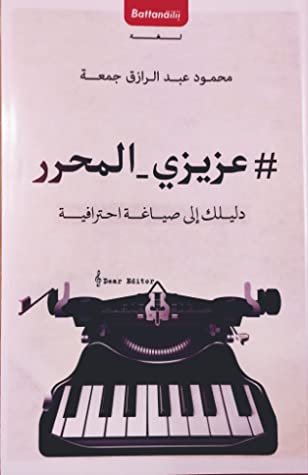

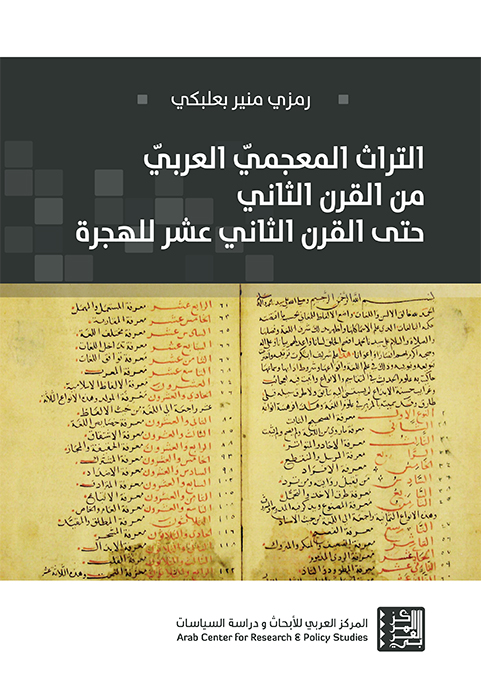
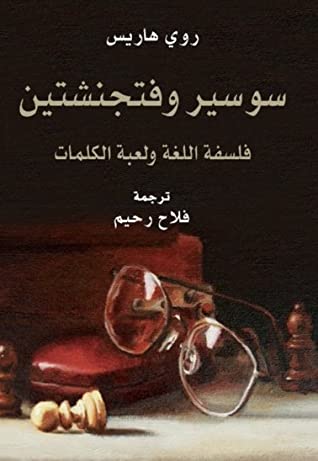

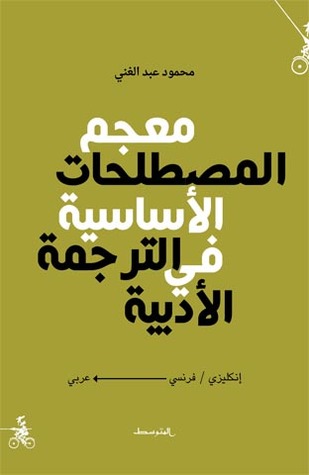

 الرئيسية
الرئيسية  المفضلة
المفضلة  الحقيبة
الحقيبة  فلتر
فلتر
لا يوجد مراجعات