موسى المصري حل لغز اثار الذاكرة
يكمن هدف بحث الذاكرة التاريخية ليس في إيجاد الحقيقة الممكنة للتراثات، مثلما هو الحال في تراثات موسى المختلفة، وإنما في دراسته هذه التراثات نفسها على كونها من ظواهر الذاكرة الجماعية الحضارية فالتذكر يمكن أن يكون خاطئاً أو محوراً أو مختلفاً أو مكوناً بصورة إصطناعية، مثلما عمت النقاشات الحديثة في مجالات التحليل النفسي والطب النفسي العدلي والسير الحياتية والتاريخ على إبراز ذلك بصورة واضحة. وفي إمكان التذكر أن يكون مصدراً أميناً دون فحصه بواسطة "الوقائع الموضوعية". ويسري هذا المفعول على الذاكرة الجماعية أيضاً، مثلما يريد الباحث تبيان ذلك في بحثه هذا، وفي فصل من الفصول، بمثال مثير للدهشة. إلا أن حقيقة التذكر بالنسبة لمؤرخي الذاكرة لا تقع في الدرجة الأولى في واقعيتها، وإنما في حاليتها. فإما أن تعيش الأحداث في الذاكرة الجماعية بإستمرار، أو أن يطويها النسيان. فلا يمكن للتاريخ أن يكون له معنى، إذا لم يتم تذكر هذه التمييزات. ويكمن سبب بقاء "الحياة مستمرة" في التذكر في الأهمية المتواصلة لهذه الأحداث والتمييزات. ولا تأتي أهمية هذه الأحداث والتمييزات من ماضيها التاريخي، ودائماً من الحاضر المستمر والمتبدل دوماً‘ والذي تثبت في تذكر هذه الأحداث والتمييزات كوقائع مهمة. ويحلل تاريخ الذاكرة الأهمية التي يعزوها الحاضر إلى الماضي. وتعتمد وظيفة الإيجابية التاريخية على فصل التاريخية من الأسطورية في التراث وتفريق العناصر التي تحافظ على الماضي ضد تلك التي تخلف الحاضر. وبالعكس تعتمد وظيفة تاريخ الذاكرة في تحليل العناصر الأسطورية للتراث والكشف عن نياتها المحتجبة. فلا يسأل تاريخ الذاكرة: "هل كان موسى عارفاً لكل حكم المصريين؟" وإنما هو يسأل: "لماذا جاءت مثل هذه الإفادة في العهد الجديد وليس في العهد القديم، ولماذا إستند نقاش موسى في القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر بصورة كلية تقريباً إلى صورة موسى هذه الجملة الواحدة (أعمال الرسل7/22)، وليس على ترجمة سيرة موسى المفصلة في سفر الخروج. إن بادرة التذكر هي إنتقائية لدرجة عالية، ولكن بحثاً تاريخياً، سواء كان من قبل علماء المصريات أو علماء الإنجيل، حول تراث موسى ومصر، سيكون أوسع كثيراً، ويتضمن بالتأكيد الكمية التي لا يستهان بها من المواد الكتابية والأركيولوجية واللغوية. هذا ولكون الباحث (مؤلف هذا الكتاب) متخصصاً بعلم المصريات، فهو يعلم جيداً ما يمكن الإستغناء عنه في هذا المجال. إذ أنه يعالج في بحثه هذا تجربة الرسالة الدينية لإخناتون، بمقدار إستمرارها في قصة المجذوبين فقط. كما أنه يعالج هذه القصة، والعداء اليهودي المصري بوجه عام، أيضاً بقدر ما يخص النقاش المتأخر حول موسى ومصر فقط. كما أنه يقرأ ميمون على ضوء سبنسر فقط، ويقرأ واربورتون على ضوء راينهولد وستيلر وفرويد بقدر إشتراكه بهذا النقاش ومطالبه فقط. وكل حالة لها طريقتها في البحث التاريخي. ومهما يكم من أمر، فقد أعطى الباحث لهذا الأثر العمودي للتذكر، الذي تابعه منذ أخناتون وحتى القرن العشرين بعنوان "موسى المصري" على أنه لا يسأل ولا يجيب هنا، عما إذا كان موسى مصرياً أو عبرياً أو من بدو الصحراء السورية. حيث تتعلق هذه المسألة بموسى التاريخي وعليه فهي تعود إلى التاريخ وإن ما يهم الباحث هنا هو موسى كشخص من التذكر.






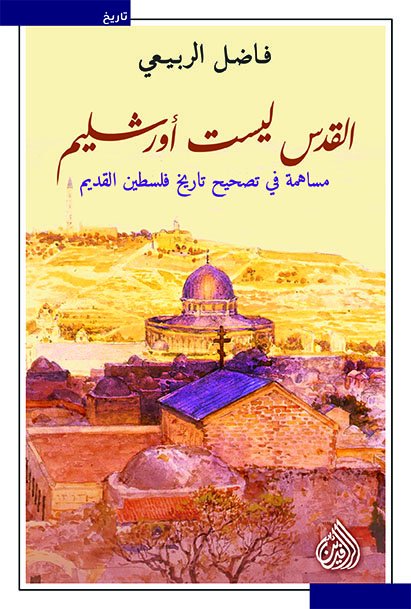

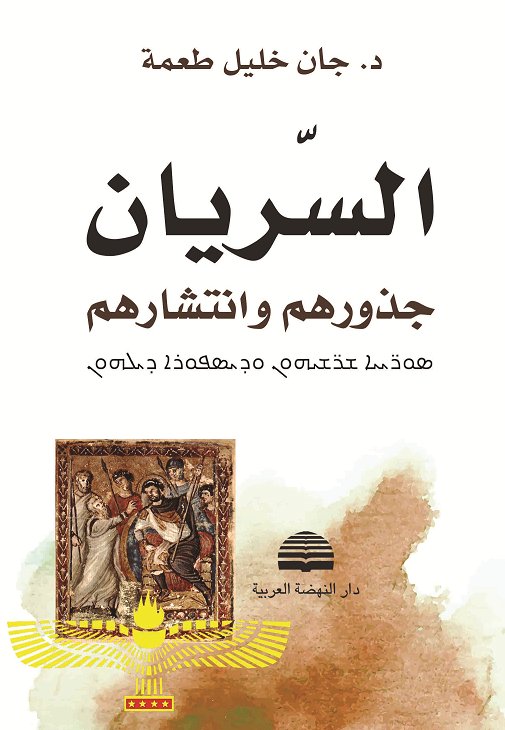
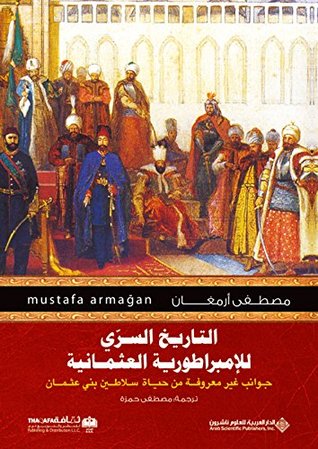
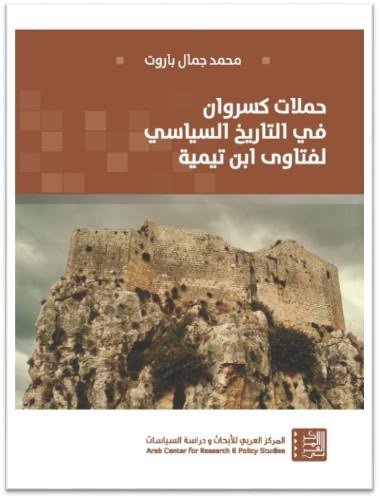
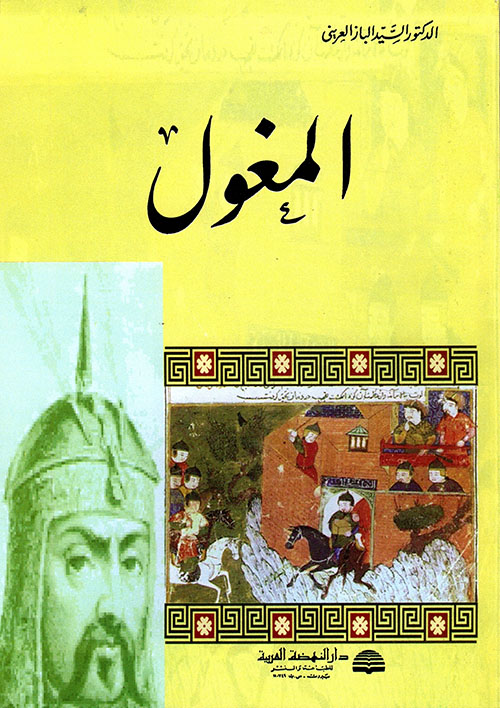
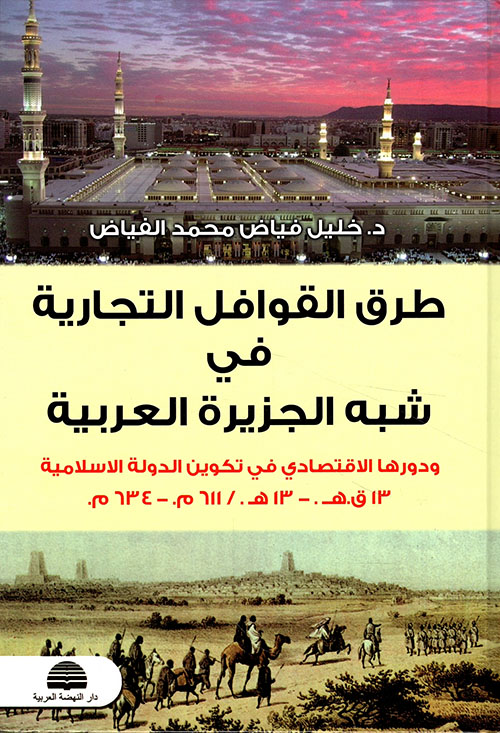
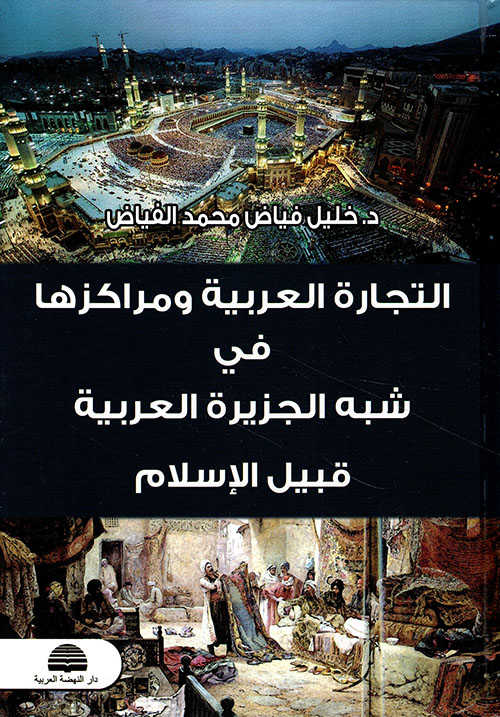
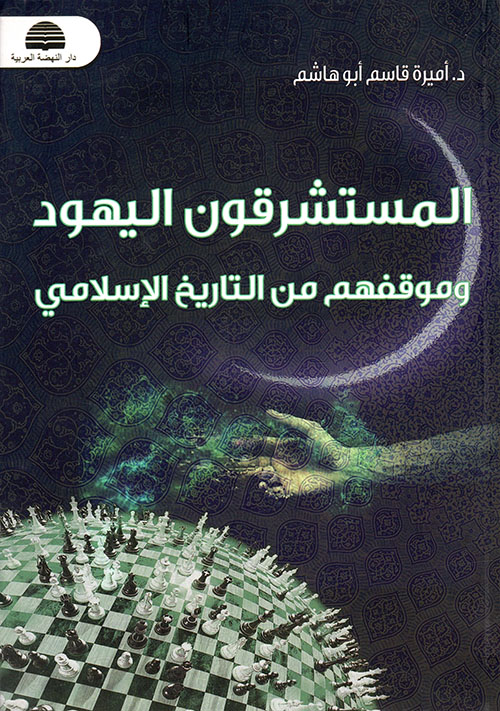

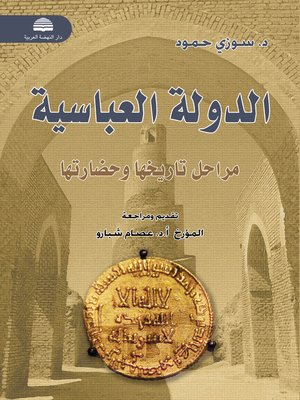

 الرئيسية
الرئيسية  المفضلة
المفضلة  الحقيبة
الحقيبة  فلتر
فلتر
لا يوجد مراجعات